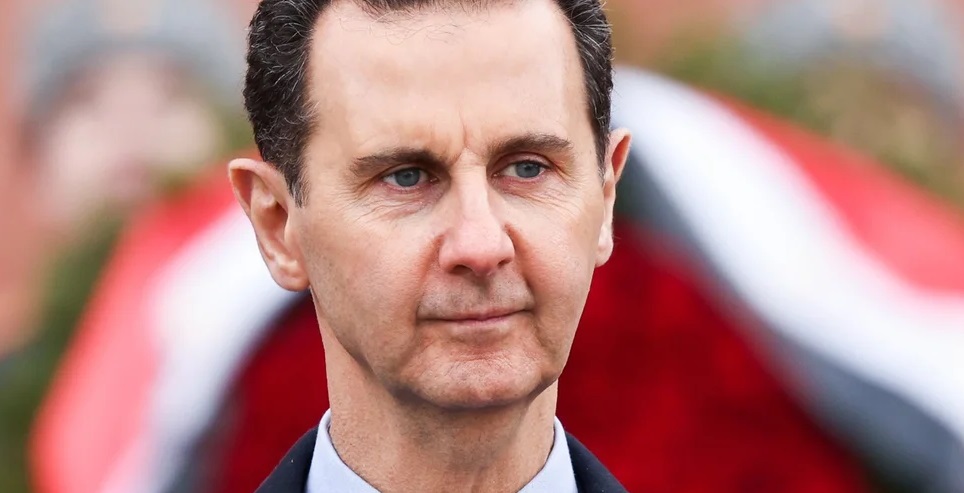عاهاتنا التي أسقطتنا في بئر أعمق من ذاك الذي كان فيه ريان
لم يسبق للمغاربة أن وجدوا أنفسهم أمام قضية تختبر الوجدان والعقل والمهنية في آن واحد كما فعلته قضية الطفل ريان أورام، الذي جذب أنظار العالم إلى قضيته، وجذب، في الآن نفسه، أنظار العالمين إلى المغرب.
وجد المغاربة أنفسهم أمام امتحان علني ينتظر الجميع نتائجه، والحقيقة هي أن أننا نجحنا في العديد من الأمور، كأن نؤكد للعالم أننا لا زلنا شعبا متلاحما يتألم لألم طفل ضعيف واقع في غيابات الجب، مستعد لتقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساعدة لإنهاء مأساته ومأساة والديه، شعبٌ لا زال يحس بالآخر ويرفع أكف الضراعة إلى الله راجيا بصدق أن يرد فتى ضعيفا عاجزا إلى أمه ليطمئن قلبها، ويبكي بحرقة حين يراها ترافقه إلى مثواه الأخير.
نجح المغرب أيضا في امتحان التكاتف، وأعطى المسعفون والمنقذون المتطوعون ومختلف السلطات صورة لم يكن أشد المتفائلين يتوقع أن يشاهدها يوما ما، حين وضعوا أيديهم في أيدي بعضهم لإزاحة "جبل" من مكانه لإنقاذ أحد أبناء الوطن، وحتى عندما انتهى الأمر نهاية مأساوية، وقف الكثيرون عبر العالم ليُصفقوا للجهود والتضحيات التي بُذلت، مُجمعين على أنه لم يكن بالإمكان أكثر مما كان، وأن كلمة النهاية كُتبت بقلم القدر الذي كان أقوى من الجميع.
نعم، إن كل هذا وغيره مثبتٌ ومختوم بختم التاريخ الذي لا يُمكن أن تُغيره تدوينة خرقاء من هنا أو تغريدة حقيرة من هناك، لكن المغاربة قطعا لم ينجحوا في جميع الامتحانات، بل إن السقوط الأخلاقي والمهني الذي برز بشكل فضائحي طيلة 5 أيام، ربما كان أقسى من سقوط ريان وسط البئر، بل لو قُدِّر للطفل، مجازا، أن يلقي نظرة أسفل جسده العالق في منتصف الحفرة، لرأى جثامين بعض الضمائر موجودة في القعر السحيق.
لقد أماطت الفاجعة اللثام عن عاهات فئة غير يسيرة من إعلامنا وعن عقلية الكثيرين ممن جعلوا منصات التواصل الاجتماعي فضاءا للاتجار بالبشر، حيث أضحت مآسيهم السلعة المعروضة التي تُقتنى بعُملة "البوز" الذي يبتغي كثيرون تحويلها فيما بعد إلى الدرهم واليورو والدولار، ولا يهم أن تكون مُلطخة بالدماء ولا مسقية بالدموع.
كان الإعلام لاعبا أساسيا في هذه الحكاية، وبالتأكيد كان العديد من الصحافيين المغاربة الذين غطوا المأساة لفائدة مؤسسات وطنية ودولية على درجة عالية من المهنية سالكين مسلك التروي والتحقق حتى في فترة صارت فيها المعلومة الدقيقة شحيحة جدا، لكن ما يدعو للحسرة والغضب في آن واحد هو أن جحافل المصورين الذين لا يتقنون إلا إشعال الكاميرا وإطفاءها ومد الميكروفون هنا وهناك، ومعهم جيش من الذين أصبهم مس "التعليق المباشر" و"التمثيل الهابط" غطوا بجرائمهم في حق المهنة والإنسانية على طيب العمل وأحسنه.
لم تعد المأساة ُمأساةَ ريان وأهله فقط، بل أيضا مأساةً هي الأسوأ من نوعها للفضاء الإعلامي المغربي في زمن أصبح فيه زعم الانتماء لمهنة المتعب أسهل من قول "السلام عليكم"، وأضحت ضريبة "الاستقطاب المفتوح" و"ادخلوها بصباطكم" أغلى من أن يتحملها من يرون في مهنة المتاعب رسالة وفلسفة لا تنفصلان عن الضمير والأخلاق... كان علينا طيلة 5 أيام أن نتحمل "عار" ما صنعه أشخاص تُسعفهم جباههم العريضة أن يقولوا إنهم "صحافيون".
لكن مصابنا لم يكن في الصحافة والصحافيين فحسب، بل لا مُبالغة في القول إن ما يصنعه الفريق الطالح من هؤلاء كان ليُجابهه عملُ الفريق الصالح، لو كان "قصف" قواعد وأخلاقيات المهنة يأتي من جهة واحدة فقط، لكن الغول الذي تحرر دون أن يستطيع أحد مواجهته كان هو المسمى كذبا وبهتانا "مواقع التواصل الاجتماعي"، والحق، أنه كان ينبغي أن استخدام وصف "مواقع الزيف الاجتماعي".
إن مأساتنا في أنفسهنا هي أن نعاين بعض بني جنسيتنا لا يخجلون من الانتقال من أقاصي الشرق والغرب والجنوب في اتجاه قرية معزولة منسية في نواحي شفشاون لم يكونوا يعرفون حتى أين تقع على الخريطة، فقط لالتقاط صور لحساب "إنستغرام" أو إطلاق بث مباشر من صفحة "الفيسبوك" أو نشر فيديو على قناة "اليوتوب" مضيفين إلى كل ذلك توابز "الإثارة والتشويق" التي تترجم إلى "الزيف والبهتان"، حتى تحولت الفاجعة إلى أكبر "سيرك" مفتوح في تاريخ المغرب.
ما أفظع أن يكون الموت البطيء لطفل في الخامسة من عمره وسط الظلام والجوع والبرد أمام عجز والديه، وسيلة للفرجة وللتسويق ثم لجني الأرباح السهلة القذرة، وهذا هو التوصيف الصحيح للاستغلال الذي تعرضت له "تراجيديا" ريان من أشخاص لم يتوانوا عن الاعتراف بأنه لم يأتوا إلا لجني أكبر عدد من المشاهدين لصفحاتهم وقنواتهم، وهو أيضا ملخص شافٍ ووافٍ للعقد النفسية التي اعترت أفراد شريحة غير يسيرة من مجتمعنا، ممن ألغى العالم الافتراضي إحساسهم بجدية الواقع.